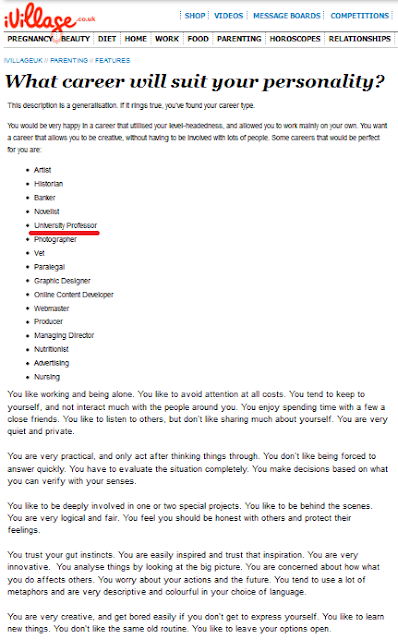في لحظة رواق، فاجأتني الذاكرة بأن عادت بي لأيام بعيدة، سحيقة في البعد.
أتذكر أول أيام وعيي بالعالم في ليبيا، حيث عشنا عيشة التقشف التي ليس بها حتى الحد الأدنى من اللهو البريء. أتذكر صندوقاً كان تحت سرير أبي. كان الصندوق يحوي كتباً كان يُدَرِسُ منها للمرحلة الثانوية: المنطق، علم الكلام، علم النفس في حياتنا اليومية، التاريخ الإسلامي، الفلسفة، علم الاجتماع. كان أبي مدرس علم نفس واجتماع (وفلسفة ومنطق ولغة إنجليزية لحد مايجيبوا مدرسين فلسفة ومنطق ولغة إنجليزية). وكان الصندوق يحوي إضافة لهذه الكتب كتباً أخرى يجمعها أبي في نهاية كل عام دراسي من أروقة المدرسة بعد أن يلقي بها الطلاب سعداء: النصوص والشعر للثانوية العامة، القراءة الحديثة للثانوية العامة، تراجم شكسبير، الوعد الحق، قصص الأنبياء. كما احتوت المجموعة على مجلدات بهجة المعرفة للصادق النيهوم (التي ضمها أبي للصندوق في أواخر أيامنا بليبيا، وحوت قصة الحضارة والعلم والكون والإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث). كنت في بدء وعيي غير مدركة لما يحويه هذا الصندوق من كنوز، فكنت أخرجه خلسة وأبحث عن الكتب التي تحتوي الرسومات، وأدى هذا لأن أختار في أول تعارفي بالصندوق كتاب الوعد الحق، وأقرأ بعضاً منه بما تيسر لي مما تعلمته قبل دخولي المدرسة، ثم ألون الرسومات بأي أقلام تلوين أجدها في البيت.
عندما انتظمت في المرحلة الابتدائية، لم يكن لدي ما أفعله في الصيف؛ لم يكن لدينا أنشطة صيفية، ولا "فسح"، ولا برامج ترفيه تليفزيونية (كانت الحرب اللبنانية على أشدها وكان التلفزيون الليبي يمسينا ويصبحنا بمشاهد القتلى وبساعة يتيمة من كارتون الأطفال). وكان أن بدأت عادة صيفية مقدسة استمرت معي إلى أن عدنا إلى مصر: كنت في أول يوم للعطلة الصيفية أخرج صندوق الكتب من تحت سرير أبي وأنا أرتجف جذلة من الإثارة كما لو كان صندوق لعب جديدة، ثم أقرأ كل ما به من كتب طوال شهور الصيف. كان أول ما قرأت بعد "الوعد الحق" كتاب "علم النفس في حياتنا اليومية"، وتعلمت منه ما معنى الارتباط الشرطي، وما هي تجربة بافلوف، وما هي أنواع الفوبيا (الخوف المرضي) المختلفة، وكيف تتم جلسات العلاج النفسي، وماهية الدفاعات النفسية التي يفعلها البشر في مواجهة الضغوط النفسية، وما معنى القلق المرضي، والمعنى العلمي للهستيريا، ومرضاً عجيباً اسمه النوراستينيا (Neurasthenia) والذي يتضمن الشعور بأعراض جسدية كالوهن والأوجاع ليس لها تفسير فيسيولوجي محدد. وكان من أهم ما تعلمته من هذا الكتاب هو "كيف تقرأ بسرعة"، وملخص هذا أن العقل البشري يمكنه إدراك سطر كامل من الكلام رؤية وفهماً إذا ما ركز على ثلاث نقاط في كل سطر: البداية والمنتصف والنهاية. وغَنِّي عن المقال أنني أكملت قراءة الكتاب باستخدام هذه الطريقة، ومنذ ذلك الحين وأنا أقرأ الكتب والمقالات هكذا؛ مبتدأ، منتصف، وآخر.
تلا هذا الكتاب كتاب علم الكلام، وهذا الكتاب بالذات كان محيراً بالنسبة لي وقتها، فقد تخيلت أنه كتاب عن تعلّم كيفية "الكلام"، وأذكر أنني قلت في نفسي: "ياي! سأتعلم أخيرا كيف أتحدث بشكل جيد!"، لأفاجأ بأن علم الكلام هو العلم الذي تَعرَّض للجدليات التي صاحبت بعض المسائل الشائكة في عقائد الإسلام، كالقول بقدم القرآن أو حدوثه، وفرضية القدرية والاختيار، وصفات الله، بهدف إثبات تلك المسائل بالدليل العقلي والحجج المنطقية. لك أن تتخيل أيها القاريء الكريم أن تقرأ البنت ذات الست سنوات قصص الوعد الحق وعلم الكلام وتتعرف على صراعات الصحابة وجدليات الدين قبل أن تدرك ماهية الدين نفسه. أجزم بأن هذين الكتابين تحديداً هما ما جنبني أن "أشتري" موجة تدين التسعينات الشكلية التي جرفت مصر في طريقها، وعلّماني أن أفكر في كل ما يعرض لي في أمر ديني بالمنطق والتفسير المتسق مع العقل. أذكر أنني وقتها كتبت خطاباً أتحدث فيه مع نفسي مثبتة وجود الله بالدليل المنطقي بما تأتى لفتاة لم تتعد العشر سنوات، ولكني أضعت ذلك الخطاب للأسف مع ما أضعت من أشياء كثيرة.
ثم كان أن قرأت كتب المنطق والفلسفة وبعض تراجم لشكسبير وعلى هامش السيرة لطه حسين. لم أستمتع كثيرا بالفلسفة، ولكن المنطق كان أكثر من رائع، وقد كان من الممتع أن أدرس فيما بعد في الجامعة التصميم المنطقي والذكاء الاصطناعي، لأجد كتاب المنطق ذاك يسعفني في دراستي واستيعابي لهاتين المادتين. ولكن أهم ما استفدته من كتاب المنطق كان كيفية سوق الحجة المنطقية لدحض (أو توكيد) نظرية ما. وكلما جرفتني العاطفة في جدال ما، تذكرت بعضاً مما كنت قرأته في ذلك الكتاب لأستعيد الهدوء وأُرسي هذا المبدأ في حياتي: "إن لم تكن تعلم، لا تتكلم". أما تراجم شكسبير "تاجر البندقية" و "الملك لير" فكانت قراءتها متعة فائقة لم تكن تَعلوها متعة في كل المجموعة، وقدمتا لي أفكاراً كالعقاب والحيلة والصدق وزيف المظاهر وأهمية البحث عن جوهر الأشياء، فتعودت منذ ذلك الحين أنني، وإن كنت أحب المظاهر، لا يجب أن أنخدع بها عن إدراك الصدق وتحريه في تعاملي مع المواقف والناس والأشياء. أما على هامش السيرة فقد قرأت الجزأين الأول والثالث، وكان الجزء الأول قراءة سحرية في العالم قبل النبوة، تقرب من الميتافيزيقا، أما الكتيب الثالت فكان رصدا لتحولات المجتمع الإسلامي بعد النبوة، وكيف أضحت المصالح والصراعات سيدة الموقف، في ثيمة تقرب كثيرا من "الوعد الحق". لقد أحببت الوعد الحق كثيرا، لأنه كان يرصد جانبين من الدعوة يغفل عنهما الكثير: الفقراء وسيرتهم، ودورهم في تشكيل الصراع الذي كان طبقياً بقدر ما كان سلطوياً. انتصر طه حسين في الوعد الحق للفقراء، وتكاد هذه أن تكون المرة الوحيدة التي ينتصر فيها للفقراء في كتاباته، ربما لأن الفقراء هنا كانوا إيجابيين في صياغة حياتهم ومواقفهم ولم يكونوا مطية للمجتمع من حولهم يشفق عليهم وقتما يشاء ويستغلهم كيفما يشاء.
أجمل ما كان يحدث لي عند نهاية كل صيف بعد أن أكون قد أتممت قراءة كل تلك الكتب هو أنني كنت أكتشف أنني فهمت أشياء جديدة لم أكن أفهمها العام السابق، وجعلني هذا أدرك كيف أن فكري كان ينمو مع كل عام بما كنت أتعلمه في المدرسة. وقد كانت بيئتي التعليمية ممتازة بحق: كان معظم الطاقم التدريسي أستاذات فضليات، وكن يجمعن بين التحرر الفكري والاستقلالية بشكل لم أدرك مدى روعته إلا عندما رأيت المدرسات المصريات في المرحلة الثانوية .. كانت لديّ مدرسة لغة عربية لا تتحدث منذ بدأ الحصة إلا باللغة العربية الفصحى، وهكذا أحببنا النحو والإعراب، وكانت لدي مدرسة تربية دينية "غير محجبة" هي من علمني أن أتوقف عند مفهوم ودلالة كل كلمة أقرؤها - في درس "العفو عند المقدرة"، ما معنى كلمة عفو؟ وما معنى كلمة مقدرة؟ وما هو التناسب الأمثل بينهما الذي يخلق الموقف الذي يكون عنده العفو عند المقدرة شيئا محموداً؟ وكانت لديّ مدرسات رياضيات ساعدنني في ترسيخ التفكير المنطقي الذي زرع نواته كتاب المنطق، وكانت لديّ مدرستان للعلوم هما من علمتاني أن لا أتصدى لمهمة إلا إن كنت أعرف أنني سأستطيع إتمامها. كنا نقف في طابور الصباح بكل احترام ونمارس الرياضة (الحقيقية) نصف ساعة قبل بدأ الحصص، وكنا نقوم بالتجارب العملية في معامل العلوم، وكنا نمارس العديد من الأنشطة الفنية والأدبية؛ التمثيل والموسيقى والرسم والخط ومجلات الحائط والإذاعة المدرسية - التي كان يجب علينا أن نعدد موادها بأنفسنا من قراءاتنا في الكتب والمجلات الثقافية ك "العربي الصغير" و "المختار" و "ماجد". لم أترك مجالاً خارج حيز الدراسة إلا واشتركت فيه، وساهم هذا في أن أوسع من مداركي أكثر فأكثر، لأعود إلى صندوق كتبي كل صيف وأنا أكثر لهفة لاستيعاب "الجديد" فيه. كان الصندوق هو هو لا يتغير، وكانت الكتب هي هي لا تتغير، ولكنها كانت في ذات الوقت تكبر معي، وكأنها "تطير" معي محلقة أعلى وأعلى في كل عام إلى عوالم لا يراها غيري. كانت تجربة فريدة، وكنت محظوظة بحق.
مع تقدم الأعوام، كبر إخوتي قليلاً وأمكنني أن أشاركهم في اللعب، ولكن لأن اللُعب كانت رفاهية لا نملك منها إلا أقل القليل، تفتق ذهننا عن أن نصنع ألعابنا بأنفسنا: كنا نجمع العلب، أي علب؛ علب سجائر، أدوية، عطور مهداة إلى والدتي من تلامذتها، أي علب، ونبني منها بيوتاً مؤثثة: أَسِرَّة وصالونات ومكتبات ومطابخ وقطع ديكور. كنا نأخذ كِسر المرايا القديمة من الشارع ونؤطرها ببقايا أقمشة مزركشة ونضعها في "البيوت"، ثم نرسم على الورق شخصيات لساكني تلك البيوت، ونصمم لهم ملابس للبيت والسهرة. تطورت لعبتنا تلك إلى كتابة سيناريوهات لما يحدث في تلك البيوت، وللتفاعل بين كل بيت مع الآخرين: قصص حب، وصراعات، وعائلات تتكون. مع تقدم السنين صار الأمر تنافسياً بيننا؛ من يجمع أفضل العلب ويصمم أجمل البيوت، وتحول الأمر إلى أعلى مراتب ال "scavenger hunt". كان كل منا يضع قطعه "الثمينة" في صندوق خاص به، وكنا نتهافت على أبي انتظاراً لكل علبة سجائر ودواء ينتهي منها، ولربما سرقنا من بعضنا في الليل أفضل القطع، ولكننا لم نفعل هذا كثيراً لأن السرقة كانت تنفضح سريعا عندما يحين وقت اللعب المشترك. وكان أن أصبح صيفي منقسما بين هذين الطقسين المقدسين: نصحو في الصباح لنشرب الشاي ونأكل الخبز المقرمش والجبن الأبيض، ثم أخرج صندق العلب لألعب وإخوتي قليلاً، ثم نصمم ملابس جديدة، ثم أقضي العصر والمساء أقرأ كتاباً من صندوق الكتب، تتخللها ساعة الكارتون مع "سبانك" أو "الحوت الأبيض" أو ساسوكي" أو "الغواصة الزرقاء" أو غيرها.
عندما أخذ والداي قرار العودة النهائي لمصر، كان أول ما فكرت فيه هو: كيف أقنعهم بأنني يجب أن آخذ صندوقيّ معي؟ لم أكن أتخيل أن أنفصل عنهما وعن طقسي الصيفي المقدس، ولكن كان لأبي الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع، لأنه من يحزم الحقائب، وقد كان هناك أشياء أهم بكثير من حفنة من الكتب والعلب. وكان أن أقنعت نفسي أنني يمكنني في مصر أن أجمع علباً جديدا في صندوق جديد، ولكن ماذا عن الكتب؟ أعتقد أن ما حدث هو أنني في آخر ليلة حزمت في الحقيبة التي كان يجب أن أحملها على ظهري بعض الكتب، لأنني لم أكن أملك ملابس إلا الفستان الذي سافرت به، ولكن حقيبتي للأسف لم تتسع لكل الكتب. كان الاختيار مؤلماً، واستقر بي الأمر أن أخذت كتب القراءة الحديثة والنصوص ومجلداً واحداً من "بهجة المعرفة" لأنها كانت أخف الأحمال. كانت كتب النصوص تلك هي من عرفني بالشعر الجاهلي والخطابة في الجاهلية ثم في أول وصدر الإسلام، وكان المحتوى لا يخجل من رصد الصراع الكلامي (شعراً وخطابة) بين طرفي الصراع العتيد على السلطة في عهد علي كرم الله وجهه، بالضبط كما رصد الصراع الجاهلي في تلك الحروب الطويلة التافهة. وكانت كتب القراءة الحديثة تلك حافلة بالقصص القصيرة مما كتب المنفلوطي وأحمد أمين وغيرهما من أدباء العصر الحديث، كما احتوت مقالات كثيرة ترصد بعض الظواهر المجتمعية كالذكاء الاجتماعي ومكانة المرأة.
هكذا كان الفراق بيني وبين صندوقيّ كتبي وعلبي، رفقاء طفولتي وبدايات مراهقتي، ومؤنسيّ وحدتي في غربة كان فيها الكثير من الأوقات الحلوة، والكثير من الأوقات المرة، والأكثر من الوحدة. لم يتسنّ لي في مصر أبداً أن أعيد بناء صندوق العلب، وكأنما كان السحر كله في ذلك الصندوق القديم، أو كأن التقدم في العمر ومحاولة التأقلم مع الصدمة الحضارية التي شكلها لي الانتقال من ليبيا إلى مصر أجبرني على أن أخرج من "فقاعة" العالم المثالي الذي كنت بنيته لنفسي لأواجه عالماً حقيقياً شرساً غير متسامح ولا راقٍ. كانت الإضافة المصرية الوحيدة
التي أضفتها للمجموعة التي استنقذتها من ليبيا هي كتابات رؤوف وصفي
في الخيال العلمي، والتي تميزت عن باقي سلسلة الجيب التي كانت تغرق المكتبات في مصر بكونها تعرضت بشيء من العمق للتأثير الاجتماعي والنفسي للتقدم العلمي على البشر. ولكن أبدا لم يكن لها نفس سحر كتبي الأصلية، التي شكّلتني، ولم تتركني أبدا، ولازلت أتذكر صفحات بكاملها عن ظهر قلب، واستطعت في النهاية بفضل الإنترنت أن أتحصل على بعضها مرة أخرى، وجمعت الكثير الكثير غيرها، وعدت ثانية إلى القراءة المنتظمة. لكن الصيف فقد بهجته منذ آخر مرة أخرجت فيها ذلك الصندوق الأبيض القديم الذي حوى كتبي الأولى وأنا أتقافز من السعادة متلهفة على قراءتها.
كم تبدو تلك الأيام قريبة جداً الآن، رغم بعدها السحيق.
وداعاً يا كتبي الحبيبة، لقد كنتِ لي خير رفيق، ولن أنساكِ أبداً.